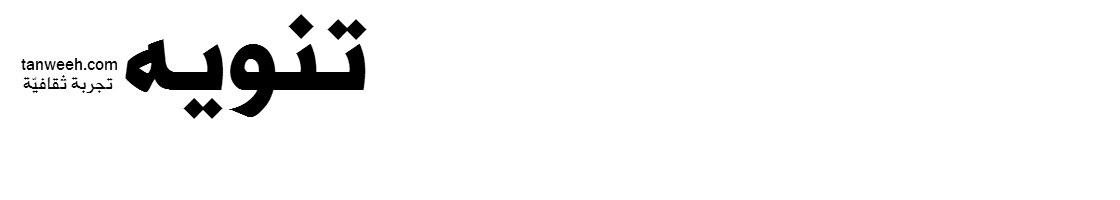fancybox example
مجد كيّال / فلسطين
في اللحظة التاريخيّة التي يعيشها الوطن
العربي ينشغل الكثير من المفكّرين والمثقفين العرب بأنفسهم، بمعنى أنهم ينشغلون
بمراجعة أنماط الثقافة وأساليب انحيازها بدلاً من اتخاذ المواقف من الواقع الجاري.
يحدث ذلك بالأساس في المساحات الثقافيّة التي امتلأت قبل الربيع العربي بنظريّات
متماسكة حول واقع الأمّة وحالها، وهي في أغلبيّتها الساحقة قوميّة ليبرالية تستند
إلى أدبيّات التحديث الإسلامي.
الحالة النظريّة توتّرت أمام واقعٍ مصيريّ
أحرجها، أحرج رؤيتها وأحرج توقعاتها وأحر منهجيّتها النظريّة، فتحوّل التنظير إلى حالة
من التكلّف الدفاعي الثقيل في تفسيره للواقع دون أن يعترف بذلك. وتحوّل التنظير
إلى استنزاف للنماذج التاريخيّة عبر القفز بين ادعاء "التعلّم من
التجارب" حين تبني التجربة قربًا بين نظريتهم والواقع، وادعاء "التاريخ
لا يُنسخ" حين توسّع التجربةُ الفجوةَ بين نظريتهم والواقع.
من حيث لا تدري، تحمل المراجعة لأنماط
المثقفين والمقارنة بينهم خلفية نظرية قويّة هي ذاتها التي تحكم الرؤية السياسية،
وهي تتأسس على مفهوم بنيوي لثقافة فاقدة للمضمون، يُمكن لمثقف في هذه الرؤية أن
يكون سلطويًا أو يكون ثوريًا، أو يرزقه الله ويكون... إصلاحيًا. مضمون الثقافة هنا
يختلف، لكنه يتساوى في البنية التي تُحدده، وتصبح المضامين شكلاً من أشكال
التعدديّة التي تتنافس فيما بينها في إطار بُنية وشروط وإجراءات للثقافة، هذه
البنية في مراجعة أنماط المثقف تنطبق ذاتها على رؤية المثقف الإصلاحي السياسيّة،
وهو ينادي في كل ركنٍ وساعة إلى الارتكاز على قواعد واضحة لتداول السياسة، قواعد
مجردة من الأيديولوجيّات.
وليس من باب المصادفة أن تتم مراجعة أنماط
المثقفين دائمًا من باب فرداني يتلخّص بسؤال: "من هو المثقف؟" ويوازيه
بالسياسة "المواطن"، فلا يتم الحديث عن تيار ثقافي ولا عن المثقفين
كمجموعة أو كهويّة أيديولوجيّة، بل كبنية أخرى مضمونها الوحيد هو الفرد،
والفردانيّة مشكلة معروفة لا داعي لشرحها عند الليبراليين عمومًا.
لا يُمكن للمثقف الإصلاحيّ أن يعيش من دون
النظام، فهو لا يتصوّر دوره من دون النظام لأن رؤيته للتغيير غير قابلة للتحقق إلا
من خلاله وهذه المشكلة الأولى. ومن جهة أخرى أدى سقوط النظام إلى ظهور الفجوة بين
المثقف الإصلاحي والمثقف الثوري في اللحظة التي لم يعد فيها النظام مطلقًا وهذه
المشكلة الثانية. بين هاذين العاملين يظهر المثقف الإصلاحي مأزومًا (وهو بتعريفه
لنفسه يجمع بين الموقف الأخلاقي والتعقّل)، لأنه من جهة فقد النظام، والنظام يكبح
الأخلاق المفرطة وحسّ العدالة المتهوّر، ويشكل بهذا الكبح ضمانًا للتعقّل السياسي،
ومن جهةٍ أخرى أدى انهيار النظام إلى فراغ تملأه الأخلاق الثوريّة وقيم العدالة
والحريّة، ولم تعد هذه القيم نغزات ضمير قبل النوم، بل صارت جرفًا فعليًا يملأ
الشوارع ولا يمكن الهروب منه، بل ويثبت أن العقلانية والواقعيّة السياسية في صفّه.
يتشكل هذا الحرج وهذه الأزمة لأن المثقف
الإصلاحي يرى نفسه أصلاً همزة وصل بين صُلب السلطة والمصلحة العامة، يرى بنفسه
جزءًا من نخبة تدور في فلك السُلطات وترى بنفسها وكيلة المصلحة العامة في هذا
الفلك وترى أن تحسين الوضع القائم يأتي من داخل هذا الفلك وليس من فلك المتضررين
من السلطة. يفترض مثقفو الإصلاح بأنهم همزة الوصل لأنهم يملكون أحد العاملين الذي
يفتقد الطرفان واحدًا منهما: يملكون الأخلاق وقيم المبالاة اتجاه من هم دون
مكانتهم، وهي عوامل تفتقدها سلطة الاستبداد، ومن جهة أخرى، يملكون الأدوات
المعرفيّة وإمكانيّات "التعقّل" التي لا يمسك العوام بتلابيبها.
المثقفون الإصلاحيون مرتبطون بالسلطة،
وخطابهم يتركّب كجزء من مناجاة السلطة، والحق أنهم قد ينجحوا أحيانًا في تغيير بعض
ملامحها من الداخل. لكن المهم أنهم مرتبطين بالنظام، وفهمهم لإمكانيّات تطوّر
الحركة السياسيّة هو فهم مسرحي: الضغط الشعبي، التحرّك الشعبي، الانتفاضة والثورة
(حتى وإن كان الإصلاحيون يقفون معها) فهي كلها وسائل دراميّة تدفع الأبطال إلى
قيادة الأحداث على الخشبة. لا يمكن للإصلاحيين فهم حركة الناس إلا كأدوات ضغط
لتحقيق توازنات بين نخب في محل خلاف، توازنات تسمح لوصول أمراء شكسبير (أو أمراء
على بياض) إلى حلول فيما بينهم بدلاً من الغدر المطلق. الإرادة الشعبيّة ليست
شرعيّة بحد ذاتها، بل هي غذاء لشرعيّة هذا الأمير أو ذاك على طاولة التفاوض أو
التداول السياسي كما يفرضها البروتوكول. وهذا ليس فقط في الوطن العربي، فقد
لمسنا هذا النهج ذاته في مقاومة الاستعمار في فلسطين، حيث سمعنا أصوات تنادي بحمل
البنادق أو بالمقاومة الشعبيّة من أجل تحقيق توازن يُفضي إلى مفاوضات نديّة.
حين يتحدّث الاصلاحيون عن الثورة، لديهم
غول واسمه "الفرز"؛ إنهم يحذرون دائمًا من إمكانيّة تحوّل الفرز إلى فرز
هويّاتي، طائفي، شعوبي. متجاهلين ومسخّفين أي حديث عن فرز مبدئي، اجتماعي، بين
مطبقي الشريعة والعلمانيين، بين الطبقات الاجتماعيّة، بين الأيديولوجيّات
والتوجهات السياسيّة. ويهبّون للدفاع عن الوحدة، وهي غالبًا ما تتحول قيمةً بحدّ
ذاتها، ولكنهم لا يسألون من المسؤول عن تحويل كل صراع أيديولوجي إلى حرب طوائف،
ولا يعترفون بأن أمراء النخبة الذين يعوّل الاصلاحيون عليهم للتوصل إلى توازن
عادل، هم المسؤولون أولاً وأخيرًا عن تحويل كل صراع بين التقدميّة والرجعيّة إلى
صراعٍ بين رجعيّتين. أمراء الحرب والإعلام، بغض النظر عن اختلاف ثيابهم ومستوى خطابهم،
هم من يطلب منهم الإصلاحيون الوصول إلى حلول عادلة، أي أنهم بالنهاية من يطبّقون
حسّ العدالة الذي تحدثنا عنه.
تضع ثقافة الإصلاح الحركة الشعبيّة (خلال
نقاشها، حتى وإن تؤيدها) أمام خيارات تختلف بالشكل، لكنها مشتركة في كونها تجتهد
لتعيد الحالة الشعبيّة اللا-سلطويّة العارمة إلى قوالب مفهومة واضحة ومحددة. تارةً
يكون الموقف بأن الحركة الشعبيّة يجب أن تحدد ممثليها، وتارةً يكون واجب الحركة
الشعبيّة الانخراط في الأحزاب القائمة لتؤثر عليها من الداخل. هذه كلها خيارات
تهدف لإحتكار الحركة الشعبيّة في مبنى محدد، حصرها. المهم أن تكون الأمور محددة
لتترتب في برج القوى المتين القائم، والتي تنهل من ديناميكياته النظريّة
الإصلاحيّة برمتها.